حياة الأسرة الفقيرة كتاب مفتوح
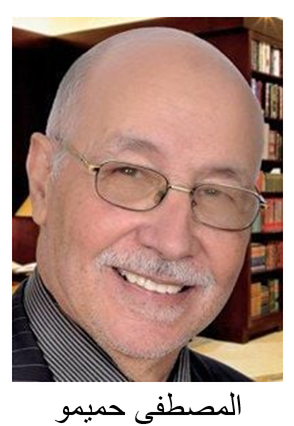
المصطفى حميمو
حين نتحدث عن عبثية أنين الحنين إلى الزمن الجميل، المثير للشفقة، نجد هناك من يبرره – وبحق – بالأسى على فقدان القيم النبيلة التي كانت تسود بين الجيران من تكافل اجتماعي وتواصل ومودة واحترام متبادل وتقاسم للأفراح والأقراح. كان الأطفال يملؤون الأزقة باللعب والصراخ والضحك وكانت النساء يتعاونّ في فترة حمل كل منهنّ حتى الولادة والنفاس ويحتفلن بالسابع كأنه عرس جماعي. وكان المرضى يجدون من يزورهم دون دعوة وكان الفرح عند أي أسرة يتحول إلى عرس للحي كله.
بل أكثر من ذلك، كانت أبواب البيوت مفتوحة طيلة النهار، تدخلها الجارة وباقي أفراد أسرتها وكأنهم من أهل البيت، تشاركهم أحيانا طعامهم البسيط دون تكلف ولا اعتذار. والعيد كان مناسبة احتفال مشتركة، حيث يحلو للجارات تبادل الأطباق فيما بينهن على بساطتها، قائلات « ذوقوا هذا من صنع يدي بالصحة والعافية ». وكان الناس يتقاسمون الجديد مما تيسّر لديهم بلا حساب ولا منّة. بل كانوا يتقاسمون همومهم ومشاكلهم فيما بينهم، فكانت بذلك الأزمات التي تحل بهم أخف وطأة، لأن الضيق يُقتسم فيذوب ويتبدد أثره بين الأفراد.
وكان الأطفال ينشأون في حضن جماعي. الكل يراقبهم ويؤدبهم ويُعلّمهم وكأنهم أبناء الجميع. وكان الشبان يكتسبون إحساساً بالانتماء للحي الذي يتجاوز حدود الأسرة الضيقة إلى العائلة الممتدة فيه بأسره. في مثل هذا المناخ البسيط حيث كلّ راض بقدره، لم تكن الخصوصية حاجة ملحّة، بل كان الانفتاح والبوح هو سرّ الطمأنينة والسكينة النفسية من دون الحاجة لا للمهدءات الطبية ولا لأي نوع من للمخدرات.
وفي مدننا العتيقة، كانت القيم الدينية والبساطة المعيشية يمدان نسيجها الاجتماعي بالقوة والطمأنينة النفسية. الجار في منزلة الأخ والضيافة فضيلة لا تسقط بالتقادم والسؤال عن الغائب أو المريض واجب لا يحتاج إلى موعد مسبق، بل يُلام من تجاهله أو أغفل عنه. والمظاهر المادية لم تكن فيها عاملاً حاسماً في تقدير الناس ولا فصلهم عن بعضهم البعض، بحيث كان بيت الفقير متلاصقا أحيانا ومن دون حرج، مع بيت الغني والشريف، وكان معيار التعامل فيما بينهم جميعا هو التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار.
لكن نفس الأسر التي كانت تعيش في أحياء الصفيح المبرمجة للهدم، وكانت حياتها مكشوفة ومليئة بالدفء والتضامن، ما إن تنتقل إلى عمارات السكن المشترك الأرقى من مساكنها المهدّمة، حتى أحياناً وحتى غالباً ما تنقلب الصورة رأساً على عقب. تُغلق الأبواب وينعدم التواصل بين الجيران وتنشأ خلافات حادة حول المرافق المشتركة التي كان يُفترض أن تكون مجالاً للتعاون ويختفي التكافل الذي كان شعار الحياة البسيطة ويتوقف الأطفال عن اللعب في الممرات والساحات الفارغة خوفا من تشكي الجيران. بل قد يُنظر إلى طلب المساعدة على أنه عيب ينقص من قدر صاحبه في بيئة أرقى من ذي قبل، حيث صار عليه أن يثبت بتعفّفه وستر حاله أنه يستحق تلك المكانة الجديدة التي بلغها.
وحتى المناسبات التي كانت احتفالاً جماعياً في الحي القديم، تُقام بصمت داخل الشقق المغلقة، بحضور الأقارب أو الأصدقاء القادمين من خارج الحي، بينما الجيران يكتفون بسماع الصدى أو رؤية بقايا الزينة بعد انقضاء الحفل. هكذا، ينحسر الشعور بالانتماء للحي ولمجتمعه، ويحلّ محله نوع من الاغتراب حتى في البلاد. حياة دائما بسيطة لكن كتابها مغلق.
أما من حول مدننا العتيقة، حيث ارتفع مستوى المعيشة وتوسع العمران، فقد ظهرت الفردانية التي رافقت التمدن العالمي كله. ونشأت أحياء خاص بطبقة اجتماعية معينة من بعد ما كانت كل الطبقات مختلطة في الزقاق الواحد. والزيارات العائلية تقلصت بحجة الانشغالات الضاغطة. والأبواب المغلقة صارت علامة على الخصوصية، لا على الجفاء، بحجة الحاجة للأمن والسلامة. وتبقى النتيجة واحدة الكامنة في انحسار الحياة المشتركة اليومية التي كانت تمنح طعم الطمأنينة والدفء الاجتماعي. الدين والتدين لم يختفِيان، بل بالعكس من ذلك، لكنه صار يُمارس أكثر في الإطار الفردي، بينما ضعفت آثاره العملية على الحياة الاجتماعية.
وليس هذا المشهد حِكراً على مجتمعاتنا وحدها. ففي أوروبا مثلا، بعد الحرب العالمية الثانية، عاش كثيرون التجربة نفسها. في بلجيكا حيث عشت فترة غير يسيرة في السبعينيات من القرن الماضي، روى لي بعض الجيران المتقدمون في العمر كيف كانوا يتقاسمون ضيق العيش وبساطته ويفتحون أبواب بيوتهم لبعضهم البعض ويتعاونون على إصلاح ما تهدّم أو مشاركة ما تيسّر من الطعام. كانوا يصفون تلك المرحلة، رغم شح الموارد، بأنها أكثر دفئاً وألفة من حياتهم التي تحسنت فيها أحوالهم المادية وارتقوا إلى مساكن أوسع في أحياء أرقى. هناك، تغيّر كل شيء. أُغلقت الأبواب وتقلصت العلاقات واستُبدل البوح بالصمت، خوفا من اكتشاف ما تبقى من العجز والفقر وما يتبعه من الاتهام بعدم استحقاق الارتقاء إلى تلك المكانة الأفضل من السابق. فصار الحرص المفرط على السمعة والمكانة الجديدة هو شعار المرحلة.
فيتضح من كل ذلك أن الارتقاء المادي لا يحافظ بالضرورة على الرقي القيمي التلقائي الملازم للحياة البسيطة. بل أحياناً وحتى غالبا ما يقترن بتحولات خطيرة على الصحة النفسية. تحول من بساطة الحياة المشتركة والمكشوفة إلى العزلة الفردانية، ومن التكافل إلى التنافر وحتى الصراع. لكن بدلا من أنين الحنين العقيم إلى الزمن الجميل الذي لا يُعقل أن نعود إليه بالعودة للفقر من جديد، سيبقى التحدي أمام مجتمعاتنا كامنا في الوعي أولا بتلك المشكلة الأخلاقية ومن ثم التفكير في سبل خلق المناخ المناسب الذي من شأنه أن يعيد لتلك القيم النبيلة الحياة من جديد في الظروف المعيشية الحالية والقادمة الأفضل من ذي قبل، كما كانت مزدهرة في الحياة البسيطة بالأمس.
وفي الختام يبقى تحقيق هذا الهدف النبيل والضروري للحياة الطيبة المحمودة والمنشودة من مهام المجتمع المدني، الذي ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا على خلقه وتنميته والنشاط فيه، ونحن نخوض في الوقت نفسه غمار التقدم المادي وننخرط فيه. فهل نستطيع أن نعيد فتح تلك الكتب المغلقة ونكتب فيها فصولاً جديدة تجمع بين الدفء الإنساني ورغد العيش؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي لا محالة رفعه، من أجل زمن جميل ديد يجمع بين الاستمتاع بنعمة تحسّن الحياة المادية من جهة والحفاظ على نعمة الدفء الاجتماعي من جهة ثانية، فيضمن لنا وللأجيال الصاعدة الصحة النفسية سليمة والحياة الطيبة.





Aucun commentaire