المدرس الاداة المنفذة للمجتمع

عندما نفكر في فعل التعلم والتعليم في نظامنا التعليمي،نجد أنه يفتقر إلى التفاعل بين وحداته المكونة،خاصة إذا عرفنا أن التعليم هو تنظيم للتعلم،كما يؤكد ذلك سكينر.Skinner وأن التعلم ترتيب إمكانات التعزيز التي تؤدي إلى تغيير في السلوك(1). لكن هذا التغيير- بما أن التعليم استراتيجية عند بعض المفكرين، تستخدم لإحداث تغيرات في أنواع السلوك،لتيسير التعلم- ألا يتطلب من المدرس معرفة تامة بهذه الاستراتيجية،وبمراحلها،وخطواتها،والإجراءات المتخذة والمتبعة؟.أم أنه يمارس تعليمه هكذا اعتباطيا؟.
عندما نقوم بملاحظة صفية،ونتتبع عمل بعض المدرسين نجد أنهم ينهجون التلقين،والإلقاء دونما اتباع هدف معين.وعندما نسألهم يخبروننا عن هدف محدد يرومونه من ذلك.ولكن ما هي الكفايات التي عملوا على تحقيقها،وتثبيتها،ونموها؟.
ربما هذا راجع إلى قناعاتهم،أو إلى نوع التكوين الذي أخذوه في مراكز التكوين. فالمتتبع للممارسة الديداكتيكية يتساءل،هلم ما يؤخذ في مراكز التكوين كاف لأن يجعل المدرس يكسب التلميذ إرثا ثقافيا؟. ويكون فكره.ويعوده على استخدام الفكر،وينمي فيه روح الملاحظة،والتحليل والتركيب،والنقد.ويستطيع أن يكيفه،ويدمجه في محيطه الصفي.أي بعبارة أوضح،هل التكوين الأساس يعطي القدرة على التأثير،وخلق علاقة تربوية بين المدرس والتلميذ؟.
صحيح أن فعل التعلم والتعليم فعل تربوي توجيهي.لان المتعلم ليس له خيارات،بل المناهج والمقررات تفرض عليه.وحتى المدرس ما هو إلا ممر،ومسهل،ومبسط لهذه المناهج.فهو ناقل للمعرفة إلى التلميذ بأسلوبه الخاص،وهذا ما يجعل المناهج،والمعارف تختلف من فصل لأخر،ومن مدرس إلى آخر.لأن لكل مدرس منهاجه الضمني.
من هنا نرى بأننا في فعلنا التربوي نقوم بعملية استنساخ ناشئة،وجيل،وروابط الإنتاج للحفاظ على ديمومة المجتمع،واستمرار يته،والمحافظة على إرثه الثقافي،ونظامه التربوي.وهذا ما جعل الكثير ينعت الجيل الحالي بالتقاعس،والخذلان،والاتكالية،وعدو الدراية.وهذا يبقى كذلك على تلك التراتبية التفوقية:المدرس/التلميذ.
هذه التراتبية تعززها سلطة معرفية،وتربوية،وقانونية.ويؤكد دوركهايم أن النفوذ الذي يتمتع به المعلم بصورة طبيعية على تلميذه نتيجة تفوقه في الخبرة،والثقافة،يعطي بثورة طبيعية لعمله القوة الناجعة التي يحتاج إليها(2).
ويؤكد الأستاذ "نخلة وهبة(3)،أن علاقة المدرس بتلميذه في المدرسة تنبني على التعلم بالصبينة.فالتلميذ مضطر إلى أن يتماهى بالمدرس،وأن يستبطن مصلحة النظام القائم خوفا من الرسوب،أو الطرد،أو العقاب،أو الإهانة أمام الأقران.كما أنه مضطر للاعتراف علنا،أو ضمنا بجهله أمام مدرسه،حفاظا على حظه في النجاح،ومكانته داخل الفصل. و لو أن التطورات التي عرفها العالم اليوم في مجال المعلوميات،والاتصال،بينت أن التلميذ يعرف أكثر من مدرسه، وأنه أكثر منه معرفة وذكاء. فهو يتحكم في وسائل السبرنطيقا،حيث إن كثيرا من المدرسين هم أميون أمامها،وأمام هذا التطور العلمي الهائل سيصبحون؛بل أصبح المدرس عاجزا عن ممارسة سلطته المعرفية،لأنها لا تساير التطور العلمي،ولا التقدم التكنولوجي.وأن معرفته محدودة بالكتاب،والتلقين،والذاكرة.
ويرى لويس ألتوسير L.Althuserبأن النظام المدرسي،هو أحد أجهزة الدولة الإيديولوجية الذي يؤمن بنجاعة استنساخ روابط الإنتاج عن طريق وجود مستويات من التأهيل الدراسي،تتجاوب مع تقسيم العمل،وعن طريق ممارسة الأنماط الإيديولوجية السائدة.وأن المسالك الموجودة في المدرسة هي انتكاس لتقسيم المجتمع إلى طبقات،وغايتها الإبقاء على الروابط الطبقية(4).وأن هذا النظام التربوي حسب بورديو وباسرون يتطابق كل التطابق مع المجتمع الطبقي،يهدف على المحافظة على النفوذ الثقافي لتلك الطبقة.ويقوم بعملية الاصطفاء التي تقصي طبقة اجتماعية ثقافية من الشباب.زيادة على أن الكلمة/ اللغة تزيد من هذه السلطة، زيادة على الامتيازــ حسب بورديو وباسرون ــ الممنوح له بأن يكون ممثل الثقافة المؤسسية،وأن يكون عامل الاصطفاء الثقافي.
إن النظام التعليمي،ومن ورائه النظام الاجتماعي/السياسي/الاقتصادي،مسؤول عن كل ما يحدث في المدرسة من رسوب ونجاح،وإهدار،وتمييز،واصطفاء،وتطبيع،وتدجين(5).
كما أن هذا النظام التعليمي نشاطاته التربوية هي نوع من العنف الرمزي،وذلك بوصفها فرضا من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معين(6).
والمدرس له قدر من المسؤولية في هذا،لأنه يتخذ إيديولوجية المنظومة التربوية المستنبطة بوعي،أو بغير وعي،بدقة وإخلاص. وهكذا نرى بأن التوجيهات الرسمية،والرصيد المعرفي،والقصد البيداغوجي المثبت في الكتب المدرسية،وفي المذكرات التوجيهية،وفي كتيبات أهداف وتوجيهات،تقولب توقعات المدرس،وطموحاته،وتقييماته.وبالتالي فإن النظام التعليمي يدجن المدرس عبر مناهج مؤسسات الإعداد،وتنظيمها ذلك :
ــ عن طريق إقناعه بأن للمدرسة دورة عمل قائمة بذاتها،ومستقلة عن الأنظمة الاجتماعية،والسياسية.
ــ عن طريق تشريبه مفاهيم نفسية قائمة على الإيمان بالفروقات الفردية،والاختلاف في القدرات والذكاء،والموهبة.
ــ عن طريق إقناعه بأن الإصلاح في المدرسة والتعليم يتم عبر التحديث في طرائق التدريس،والوسائل التعليمية(7).
والسؤال المطروح:هل يمكن للمدرس أن ينقل الثقافات الخارجية عن نطاق المدرسة إلى المتعلمين؟. وهل دوره هو تمكين المتعلمين من امتلاك الوسائل التي تتيح لهم الاتصال بهذه الثقافات؟.وهل يستطيع أن يجعل الثقافة المدرسية أكثر إغراء،وأكثر فاعلية من ثقافة وسائل أخرى والتي تعتبر ثقافة جماهيرية؟.
إن المدرس في ظل المنظومة التربوية الحالية،لا يتيح للطفل سوى مجال ضيق لتحقيق .ذاته،واستقلاليته.الشيء:"الذي يثنيه عن الثقة في آرائه الخاصة.ويشجعه على قبول آراء إلى آخرين دون تردد أو تساؤل.وهذا ما ينمي في نفسه الإذعان للسلطة".(8)
هذا يجعله لا يتعلم كيف يتخذ القرارات بنفسه،وفي المواقف يشعر بالذنب والخجل،لأنه يجد نفسه في مواقف تعرضه للمضايقة.وهذا ما جعل إريك فروم يقول:" لا شيء أكثر تأثيرا وفاعلية في سحق معنويات الفرد من إقناعه بأنه تافه ورديء."(9).
هكذا يجد الطفل نفسه في مدرسة،وأمام منظومة تربوية تقومان بنقل قيم المجتمع وعاداته الثابتة إليه عن طريق التلقين،الذي يجمع بين العقاب،والتشريب Introctrination المعتمد على الترديد،والحفظ.وبالتالي ينعدم البحث،والتجريب.ومن هنا تتحول هذه القيم الملقنة إلى الطفل سلوكا ومعيارا يسير عليه طيلة حياته.وبذلك يتعلم أن يقبل دون أن يعترض.
إن الفعل التربوي داخل منظومتنا التربوية لا يكون شخصية الطفل التكوين الصحيح،والسليم،فهو يجعل فيها اعوجاجا وشرخا.حيث يخلق فيه نوعا من العدوانية اتجاه كل ما هو مدرسي،وكل ما يدور في فلك
المدرسة.فحاجاته الأساسية لا تلبى على الوجه الصحيح،لأن المنظومة التربوية لا تؤمن بوجوده.ولا تمتعه بالاطمئنان العاطفي،ولا تستطيع أن تسيطر عليه إلا باستعمال الإرهاب والقهر،والعقاب،والجزاء.فهي لا تعترف بذاتيته،الشيء الذي يجعله يشعر بالعداء نحو المدرسة،وهو عداء مبطن باحترام ناتج عن خوف..//..
| المراجع |
1-Skinner ,(B.f) ;La révolution scientifique de l’enseignement .Bruxelles ,Dessart.1968 ,p :136
– بوستيك،(مارسيل)،العلاقة التربوية،ترجمة محمد بشير النحاس،منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،تونس،ص:15.
2-Durkheim ,(Emile) ;Education et sociologie ,P.U.F ,p :44-45
3– وهبة،(نخلة)،إعداد المعلم الأداة،معهد الإنماء العربي،الدراسات التربوية،ء1،بيروت،ص:7
4- Althusser ,(Louis) ;Idéologie d’états :sur la production .La pensée .juin ,1970 ,p :3-21
5- وهبة،(نخلة)،المرجع السابق،ص:7.
6- بورديو،(بيير)،العنف الرمزي،ترجمة،نظير جاهل،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءط1،1994،ص:7.
7- وهبة،(نخلة)،المرجع السابق،ص:10.
8- هشام شرابي ،(سليمان)،مقدمة في دراسة المجتمع العربي،ص:35-36.

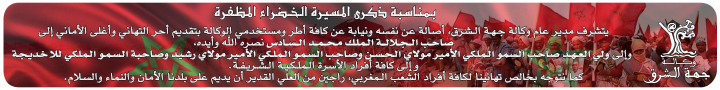


Aucun commentaire