المغرب في مدرسة العولمة من التركيب إلى الابتكار والتصنيع ترسم المملكة بتبات طريقًا حذرًا من التبعية إلى السيادة الصناعية.
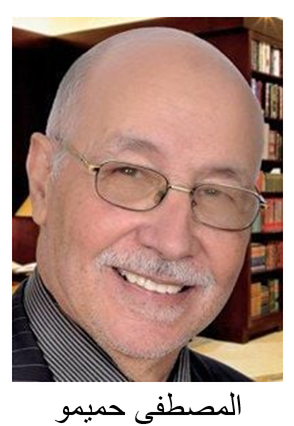
المصطفى حميمو
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 13 أكتوبر 2025 بمدينة النواصر، في المنطقة الصناعية ميدبارك Midparc، افتتاح مصنع جديد لمجموعة سافران مخصص لمحركات الطائرات. ويُعد هذا الحدث، ذو الرمزية العالية، خطوة إضافية في التحول العميق لقطاع الصناعة المغربية.
خلال العقد الأخير، أصبح المغرب واحدًا من الأوراش التكنولوجية الجديدة في العالم. الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة واليد العاملة المؤهلة أصبحت كلها عوامل حاسمة في استقطاب العديد من الشركات الصناعية متعددة الجنسيات. لم تعد شركات مثل سافران وSTMicroelectronics ورونو وسيمنس وجيميزا أو لير تكتفي بالتجميع والتركيب في بلادنا بل تصمم وتختبر وتبتكر. وعلى الورق، يبدو أن الجميع مستفيد. لكن يبقى السؤال: ما هو مقدار نصيب كل من الطرفين في هذه العولمة الصناعية ؟
بالنسبة للمغرب، تمثل هذه الاستثمارات الأجنبية محركًا للنمو ومدرسة لنقل الخبرة وقفزة نحو اقتصاد المستقبل. أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فهي تستفيد من يد عاملة مؤهلة بتكلفة تنافسية ومن سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. يتعلم الطرف الأول ويستفيد الطرف الثاني. فيبدو التوازن مثاليًا إلى حين يطرح سؤال التبعية في مقابل السيادة الصناعية.
فالتبعية المخيفة ليست اقتصادية واجتماعية فحسب، بل هي أيضًا تكنولوجية وإستراتيجية. فلما تظل برامج البحث والتنمية الصناعية وبراءات الاختراع والقرارات المصيرية في يد أصحاب رؤوس الأموال في باريس أو ميونخ أو بالو ألتو، يصبح البلد المستضيف مجرد خادم منفذ. وإذا انتقلت سلاسل المصالح من حيث الفاعلية والنجاعة التفضيلية إلى مكان آخر، فقد يخسر البلد المضيف ما بنى خلال عقود في لحظة واحدة. ويدرك المغرب هذا الخطر فيحاول تجنّب السقوط في مثالب فخ مجرد الاستضافة. كيف ذلك ؟
يستثمر في بناء مراكز التكوين التقني كمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات بطنجة والبيضاء والقنيطرة، وكجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومختلف مدارس المهندسين. ويخلق مناطق صناعية متكاملة مثل طنجة المتوسط وميدبارك وتكنوبوليس. ويعزز البحث العلمي عبر خطة التسريع الصناعي وعبر الاستراتيجية الوطنية للابتكار. فلم يعد الهدف هو مجرد الإنتاج بل التعلم وتنمية المعرفة العلمية والتحسين والتطوير والابتكار والإبداع والتصنيع. وتذكّر هذه السياسة في نسختها المعاصرة بالمسار الذي سلكته اليابان ثم كوريا الجنوبية.
في أواخر القرن التاسع عشر، جعلت حقبة ميجي الانفتاح الياباني على العالم أداة لتدارك الفجوة الصناعية بينه وبين الغرب. فتعلّم اليابانيون من القوى الغربية قبل أن ينافسوها. وفي أقل من نصف قرن تحولت اليابان إلى قوة صناعية وتكنولوجية قادرة على تحويل التبعية إلى سيادة صناعية. أما كوريا الجنوبية، فقد اتبعت وتبنت نفس النموذج في الستينيات تحت إشراف الدولة. استقبلت رؤوس الأموال الأجنبية، ودرّبت مهندسيها، وأنشأت أبطالها الوطنيين مثل سامسونغ وهيونداي وLG. واليوم لم تعد تقلّد بل تبتكر وتصنع وتصدر الصناعة الكورية الخالصة. وصارت الصين على نفس النهج لدرجة أنها صارت القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
والمغرب يتبع بدوره نفس الطريق. فهو لا يمتلك نفس الوزن السكاني ولا نفس الإمكانيات المالية لكنه يشترك معها في نفس الطموح الكامن في الصعود في سلسلة القيمة التفضيلية من حيث الفاعلية والنجاعة نحو التحكم في مصيره الصناعي. وهذا الرهان صعب، ويتطلب الرؤية المتبصرة والتخطيط والتنفيذ والمثابرة والصبر. كما يُفترض أن يبقى للدولة المغربية الدور الرئيسي في توجيه اقتصادها الاستراتيجي لتفادي الاستسلام لمنطق السوق العالمي.
فجوهر الأمر يتجاوز مجرد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تنزلق إلى التبعية. بل يتعلق بالسيادة الصناعية الكامنة في قدرة دولة جنوبية على التعلم من الشمال دون الخضوع له، وتحويل العولمة إلى أداة للتقدم بدل التبعية. لقد أثبتت اليابان ذلك بالأمس، وأكدته اليوم كل من كوريا الجنوبية والصين. ويبدو أن المغرب يريد كتابة نسخته الخاصة في نفس المسار.
لهذا الغرض هناك عاملان أساسيان لا يقلان أهمية عن أي استراتيجية وأي تخطيط، وهما الثقة في النفس والتفاؤل. فوفقًا لما يُسمى بقانون الجذب، إن الإيمان بالإمكانات الذاتية وبالقدرة على التغلب على الصعاب بعقلية إيجابية يشكلان المحرك لكل مسار طموح نحو السيادة الصناعية المنشودة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. وعلى العكس من ذلك، فإن التشاؤم يقتل كل طموح ويعيق زخم التجديد. واليوم يشكل عامل تفاؤل المواطنين ورجال الأعمال، المُقاس من خلال استطلاعات منتظمة، مؤشراً متقدماً حقيقياً على مدى ديناميكية الاقتصاد وقدرة فعاليات البلاد على الاستثمار والابتكار.
وتُظهر تجربة اليابان وكوريا الجنوبية والصين أن التفاؤل ليس ترفا، بل يشكل حافز القوة الاقتصادية الأول. فهو الذي يغذي الثقة ويشجع الاستثمار المحلي ويجذب الاستثمار الخارجي ويحفز الشباب على الابتكار بدلاً من اليأس والركون للخمول. ولكن وعلى خلاف التشاؤم الذي ينتشر تلقائيًا كالأعشاب الضارة، فإن التفاؤل مثل الشجرة المثمرة يحتاج استنباته وتنميته إلى رعاية وجهد ورؤية مستقبلية واضحة. والمدرسة والتكوين هما الأرض الخصبة لزراعته واستنباته وتنميته.
وفي المغرب فإن النشاط المتسارع بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومختلف معاهد التكوين المهني والتقني ومدارس المهندسين وباقي المسارات التقنية المتقدمة تخلق رابطًا ملموسًا ومتينا بين الجهد والنجاح، مما ينمي روح المبادرة.
وتؤكد الدراسات الأخيرة مدى قوة هذه الديناميكية من حيث يشير مؤشّر الرأي العربي 2024 إلى تحسن ثقة المواطنين في مستقبل البلاد الاقتصادي، ويعبّر 81٪ من كبار رجال الأعمال عن تفاؤلهم بنتائج عام 2025. إنه تفاؤل الجهد لا الراحة، القادر على تحويل العقبات إلى فرص والتبعية إلى استقلالية. ومن ثم، فإن تحديث الصناعة في مدرسة العولمة لا يقوم فقط على استثمار رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بل على طاقة معنوية خفية تكمن في الثقة بالنفس، وهي المحرك الحاسم نحو السيادة الصناعية المستقبلية والمستدامة.





Aucun commentaire