حين يستعلي المال والبنون على الحق والقانون
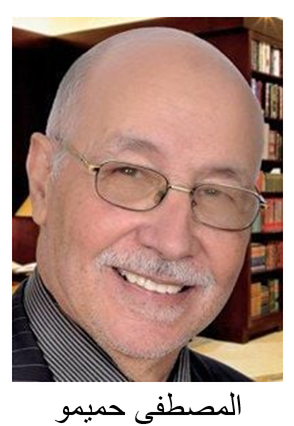
المصطفى حميمو
شاب وسيم وبطل من دون منازع رياضة المصارعة، اسمه لولكا، وُلِد وفي فمه ملعقة من ذهب ببلد معروف بأنه رمز للحرية والديمقراطية. وفي مدينته الراقية، كان اسمه يتردد بإعجاب وأبواب الفرص تُفتح له حيثما حلّ وارتحل. لكن خلف مظهر الشاب الرياضي الجذاب كان يختفي وحش يعرف تماماً كيف يفترس ضحاياه ويُفلت من العقاب.
في بلده المعروف أيضا بالتسيب الجنسي ما كانت العلاقات الرضائية لتشبع رغباته الجامحة. فكان لا يتردد في استدراج كل فتاة تستهويه وتتمنع منه كي ينفرد بها في الخلاء ليغتصبها داخل سيارته معتمدا في ذلك على قوته البدنية وكأنه إنجاز كما تعود على ذلك في حلبة المصارعة. ثم يُرغم الضحية على الصمت بالتهديد والوعيد إن هي فكرت في التبليغ عنه، متوعدًا إياها بالتشهير بها على أنها فتاة مارقة، راودته عن نفسه فأغوته ابتغاء ابتزازه. فتتحوّل في أعين الناس من ضحية إلى مذنبة ويتحول هو من مجرم إلى ضحية. فكان الخوف من مثل تلك الفضيحة وحده كافيًا لإسكاتها هي وعائلتها حتى في حال ما كانت مترفة ونافذة، وقد حصل. أما في نظره ونظر والديه وكل من هو من طينته طبقته، ففي ذلك الاغتصاب فحولة يُفاخر بها، لكن يصبح جريمة لا تُغتفر إن مس فتياتهم أو نسائهم.
واستمرّ ظلم لولكا سنوات على نفس المنوال مع العزة بالإثم، حتى افتضح أمره بين الناس، مع غصّة عالقة في الحلق ومرارة العجز عن وضع حد لعدوانه. لكن تهديداته بالتشهير لم تعد تُرهب ضحاياه أو تمنعهن من الإبلاغ عن جرائمه، إذ غدا الجميع مستعدًا لتصديقهن. عندها كسرت ضحيتان جريئتان، جَنين ونيكول، من أوائل من اعتدى عليهن، جدار الصمت، بعدما أصبحت لكل منهما أسرة وأطفال، وقررتا نبش ذلك الماضي المرير ومواجهته بشكوى رسمية كما كان يترقب ذلك الجميع من سلطات ورأي عام، إذ لا متابعة قانونية من دون شكوى.
لكن ما ظنّه الكثيرون بدايةً ليوم مشهود في تاريخ العدالة بتلك البلاد، تحوّل سريعًا إلى عرض عبثي يفوق التصوّر. فعلى الرغم من وضوح الوقائع وثبوت الجرم ونطق الضحايا بالحقيقة لم يكن ذلك كافيًا لإبقاء الجاني في سجن الاحتياط على ذمة التحقيق، بل أُطلِق سراحه بكفالة مالية كطوق نجاة وكأنه سُنّ أصلاً لحماية من يستطيع أن يدفع من دون سواهم، من المكوث والمبيت خلف القضبان على سرير بئيس بدلا من الفراش الوثير في انتظار المحاكمة.
ولما شعر لولكا، وهو طليق، بأن شبح الإدانة والسجن قد اقترب، لم يقبل والداه بذلك، بحجّة أن تلك العدالة المعصوبة العينين لا تليق بأمثالهم. فسهّلا له الهرب بجواز سفر مزوّر، وخرج من البلاد كأن شيئًا لم يكن، ليعيش حرًّا طليقًا يتنقّل بين الدول التي لا تلاحقه فيها مذكّرة الاعتقال. هرب في سفرية ملأى باللهو والترفيه، كان لا يتردّد في تصوير لحظاتها الممتعة وإرسالها للنشر عمدًا عبر وسائل الإعلام، متحدّيًا بذلك القضاءٍ الذي ينتظر عودته لإنصاف ضحاياه من جرمه. فبسبب نفوذ والديه وأموالهما، لم يعد هناك قانون يردعه ولا مذكّرة توقيف تطاله، وكأن العدالة نفسها تخجل أن تطرق بابه وهو يستمتع بوقته نكايةً في الجميع. حتى أنه خرج في الإعلام وهو يبتسم ليقول ساخرًا أن الأرض أوسع وأرحب من أن يبقى في بلد يلاحَق فيه ظلمًا.
وقد اعترف محاموه بأن متابعته في قضيتن مرة واحدة كان سيشكل مخاطرة كبيرة أمام هيئة المحلفين. ويبدو أن خوف والديه من ذلك هو ما شجعهم على تهريبه إلى حين تغيير محتمل للقانون لصالحه. وهو ما حصل بالفعل في غيابه، بحجة أن المحاكمة العادلة تقتضي النظر في قضية واحدة لا أكثر. وكثيرون رأوا في ذلك دليلاً على أن حتى التشريع من الممكن أن يتكيف هو كذلك مع مصالح أصحاب النفوذ، بالرغم من عدم وجود دليل قاطع على ذلك.
لكن وسائل الإعلام، التي كانت تنشر صوره الفاضحة كمستهتر بالحق والقانون وكهارب من العدالة، بدأت تتّهم والديه صراحةً بأنهما وراء تهريبه. فارتفعت أصوات الرأي العام مطالبة بمحاسبتهما. عندها فقط استسلم لوكا خوفا عليهما، فتم جلبه للمحاكمة التي تنتظره. لكن من بعد أن جُنِّد لصالحه فريق من أبرع المحامين. فلم يُقدَّم للقضاء كمغتصب متسلسل توفرت كل الأدلة ضده، بل كضحية لحقد الطبقات الدنيا على أبناء الأثرياء والنخب مثله.
ووفق تقاليد ذلك البلد، تبتّ في القضايا الجنائية هيئة محلفين يُختار أعضاؤها عشوائيًا من عامة الناس، حتى وإن كانوا لا يفقهون شيئًا في القانون ولا في القضاء. فتتحول المحاكمة، التي يُفترض أن تجسّد العدالة الشعبية، إلى مسرحية يكتب فصولها ويؤديها المحامون الأكثر براعة، لصالح موكّليهم. يستغلّ هؤلاء مشاعر المحلّفين ومخزون أحكامهم المسبقة وانعدام خبرتهم في القضاء، وهم المواطنون البسطاء المكلّفون بالفصل في القضايا الجنائية المعروضة عليهم.
وهكذا انتهت القضية الأولى ببراءة المتهم، بعدما نجحت هيئة الدفاع في زرع الشك في نفوس المحلفين، من خلال التشكيك بسهولة في شهادة الضحية جَنين أمامهم، بسبب تفصيل بسيط لم تستطع تذكّره بدقّة، وسط التوتر الشديد الذي صاحب لحظة اغتصابها. فخرجت من تلك المحاكمة وكأنها تعرّضت لاغتصاب ثانٍ أشدّ قسوة من الأول، لأن هذه تكذيبها تم هذه المرة علنًا، وأمام أنظار عائلتها، بينما كانت الجريمة الأولى قد وقعت على الأقل بعيدًا عن العيون، ولم تُكشف إلا بمحض إرادتها ا. وخرج منها المتهم لوكا مبتسما ومتشفيا في الجميع.
الضحية الثانية نيكول، وقد أرعبها احتمال أن تلقى نفس المصير المؤلم، كادت أن تسحب شكواها. لكن جَنين التي كانت مشمئزة مما تعرضت له، شجعتها على المضي قدمًا، ووعدتها بأن تمثل شخصيًا كشاهدة قوية مستندة إلى تجربتها السابقة. وبهذه الشهادة، يتم الالتفاف، دون خرق، على القانون الجديد الذي يمنع النظر في قضيتين في ملف واحد، ولو كره محامو المتهم.
وهذه المرة، صرحت هيئة المحلفين بأن المتهم مذنب. ومع ذلك، كانت العقوبة التي قررتها لاحقا مخففة، ورافقها تعاطف الإعلام الذي كان يتحامل عليه، بحجة أن مستقبل الشاب لولكا الواعد لا يستحق الدّمار بسبب نزوات مراهَقة. وذلك بغض النظر عن تدمير حياة العديد من ضحاياه.. فقضى ثماني سنوات فقط في السجن بدلًا من ستة عشر، لحسن السلوك.
فالمال والجاه انتصرا هنا مجددًا على القانون والعدالة. وويلٌ للأغلبية التي لا مال لها ولا نفوذ ولا محامٍ بارع، إن هي زلّت في حق قوي أو تجرأت على التشكي من ظلمه. وليست هذه القصة شذوذاً في منظومة يُفترض أنها نشأت في الأصل على أساس قدسية مبدأي الحرية والعدالة. بل هي مرآة تعكس واقعا يُقاس فيه العدل بازدواجية المعايير لما يتساهل مع الذنب إذا ارتكبه المترفون ويتشدد بصرامة إن صدر من غيرهم.
وهي نفس الطبقة المترفة والنافذة التي غالبا ما تحكم، بشكل أو بآخر، البلدان المشهورة بأنها تنتمي للعالم الحر، وتعطي الدروس في الحرية والديمقراطية. فلا عجب حين تتعامل مع باقي شعوب العالم بالعقلية ذاتها التي تطبقها على شعوبها. عقلية تقدّم منطق المصالح على قوة الحق والقانون. وهو واقع مرير لم يعد خافياً فتدينه شعوب هذه البلدان نفسها واليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما مع ظهور مآسٍي إنسانية لا تحتمل. بل تدينه أحياناً بشكل أكبر وأقوى مما يعبّر عنه غيرها من الشعوب. ومع ذلك يواصل حكّامها المضي في طريقهم لا يبالون وكأن شيئاً لم يكن.
فهل من المعقول أن يدوم هذا الواقع المرير على نفس الحال؟ لا أبدا ! فالتاريخ يُعلمنا أن الظلم مهما طال ينفجر وينكسر. وأن الشعوب قد تصبر لكنها لا تنسى، فتضل تناضل حتى تنتصر. وأن موازين القوة مهما اتسمت بالتبات فإنها لا تلبث أن تميل ثم تسقط وتندثر. ومتى ما اجتمع الوعي بالحق مع قوة الإرادات تغيرت المعادلات والمسارات في الاتجاه الصحيح. وهكذا ظلت البشرية تتقدّم عبر العصور، وإن ببطء شديد، لكن بثبات. ومهما قيل، وبالنظر إلى مجرى التاريخ، فإن الحاضر، من نواحٍ كثيرة، يبقى دائما أفضل بقدؤ ما من الماضي. ولو بُعث من في القبور الذين ماتوا حتى من قريب، لشهدوا بذلك، لكن لأننا ما عشنا حقا ما عاشوه أو ننسى فلا نشعر. فلا يأس من رحمة الله.





Aucun commentaire