الدستور بين الواقع والمسطور
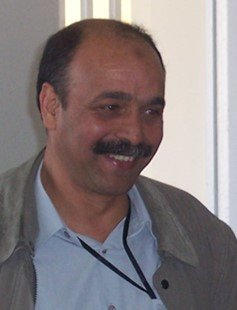
بسم الله الرحمن الرحيم
الحسن جرودي
الدستور بين الواقع والمسطور
إن مما يميز الإنسان عن باقي مخلوقات الله، قدرته على إنتاج أفكار وتحويلها إلى واقع ملموس، علما أن العلاقة بين إنتاج الأفكار ذات التأثير الفعال في الأفراد والمجتمعات، وتجسيدها في الواقع ليست أوتوماتيكية، وإنما غالبا ما تمر بمرحلة وسيطة هي مرحلة التدقيق والتمحيص قبل الإعلان عنها إما قولا، كتصريحات بعض الشخصيات، أو تسطيرا كبرامج الأحزاب والجمعيات والأنظمة السياسية على العموم… الأمر الذي يُعتبر بمثابة تعهُّد باتخاذ إجراءات التنزيل التي قد تختلف من شخص لآخر ومن هيئة لأخرى ومن نظام سياسي لآخر، وذلك ضمن سياقات معينة ووفق مجموعة من المعطيات الذاتية منها والموضوعية، مما ينتج عنه اختلاف في كيفية التعامل مع الأفكار لبلوغ النتائج المستهدفة منها، بحيث نجد من يطلق العنان لأفكاره متجاوزا مرحلة التدوين والتدقيق، بل ودون التفكير حتى في كونها واقعية أو غير واقعية وبالأحرى بلوغ أهداف بعينها، ومن يعلن عنها معتقدا أنه استوفى شروط التمحيص، لكنه سرعان ما يجد نفسه أمام مجموعة من العوائق المستجدة أو التي لم يتم استحضارها أثناء عملية التمحيص والتي تعيق عملية التجسيد، وهناك من يحرص على مطابقة قوله لفعله بحيث لا يُفرج عن فكرته لا قولا ولا تسطيرا إلا إذا تأكد من توفر الحد الأدنى من شروط استنباتها.
مناسبة هذه المقدمة هي من وحي التدبر في بعض الأفكار التي تم تسطيرها في ثنايا الدستور المغربي، وفي مدى تجسيدها على أرض الواقع. وبما أنني لست لا رجل قانون ولا رجل سياسة، فسأكتفي بمقارنة المسطور في وثيقة الدستور مع أثره في واقع المغاربة بالنسبة لنقطتين أساسيتين هما على التوالي، ما يتعلق بدين الدولة واللغة الرسمية للبلاد، ثم طرح تساؤلات في شأنهما.
ففيما يتعلق بالدين سُطِّر في الدستور أن دين الدولة هو الإسلام، مما يُفهم معه أن القوانين المعتمدة في البلاد تستمد مشروعيتها من الدين الإسلامي، وما عدا ذلك فهو لاغٍ، الأمر الذي يبدو مناقضا لمجموعة من الممارسات والأحكام التي يزخر بها الواقع المعيش، والتي لا صلة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، والمثير للاستغراب هو بروز مجموعة من الجمعيات والمنظمات المسندة من الخارج، بل وحتى وزراء من داخل الحكومة نفسها هدفهم تعميق الهوة بين منطوق الدستور وواقع المغاربة بالإجهاز على ما تبقى من الأحكام الشرعية التي لا زال يُعمل بها في مدونة الأسرة لا غير.
أما فيما يتعلق باللغة الرسمية التي كانت تنحصر في اللغة العربية في دستور 1996 لتنضاف إليها اللغة الأمازيغية في دستور 2011، فقد كان من المفروض، خاصة وأن التعريب كان من بين أهم المبادئ الأربعة التي تَبَنَّتْها اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، أن تكون العربية قد قطعت أشواطا في كل المجالات الحياتية للمغاربة، انطلاقا من تعريب الإدارة والتعليم والصحة… وآنذاك يمكن التفكير، وليس قبل، في إردافها بالأمازيغية التي أَعتبِر أن استغلالها بالشكل الحالي عنصر تشويش قبل أن يكون عنصر لم شمل المغاربة، خاصة وأن الكل يعلم أنها حروفها قد خرجت من مختبرات الأكاديمية البربرية بفرنسا، كما صرح بذلك العديد من الخبراء، على رأسهم البروفيسور والخبير بِأَصْل اللغات رشيد بنعيسى، غير أن شيئا من هذا لم يحصل، بحيث لا زالت العربية تترنح في مكانها، بل تراجعت بشكل رهيب، كما أن المستغلين للأمازيغية لم يساهموا في حل أي مشكل من المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة، بل زادوا من زخم المشاكل الثانوية التي يراد إلباسها ثوب الجوهرية، هذا كله في الوقت الذي لا زالت الفرنسية هي السائدة في مختلف المجالات الحساسة، بل وأصبحت تُرسِّخ أقدامها يوما بعد يوم إن على المستوى الرسمي من خلال فرض تعميم تدريسها ابتداء من السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، ومن خلال سحبها البساط من تحت قدمي اللغة العربية في شأن تدريس المواد العلمية بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والثانوي على الرغم من مرور أكثر من 60 سنة عن الاستقلال!، ونفس الشيء وربما أخطر منه ما يلاحظ على المستوى « الشعبي » بحيث هناك شبه تعميم للغة الفرنسية في تسمية المحلات التجارية والمقاهي، بما فيها تلك التي تتواجد في الأحياء المهمشة، بل الأدهى والأمر هو تعامل خلق كبير من المنتمين للطبقة المثقفة وشبه المثقفة مع الفرنسية، بحيث لا تكاد تجد من لا يستعملها وذلك إما استعلاء وإما جهلا بالعربية.
وإذا كان لأهل السياسة والسلطة وحتى منخرطي بعض الجمعيات والهيئات تبريرات لتغذية هذا النوع من المفارقات بين ما تم تسطيره في الدستور وبين ما يطبق على أرض الواقع، فإن المواطن البسيط مثلي، لا يملك إلا أن يتساءل عن مدى صمود هذه التبريرات أمام حجم المسؤولية التي تتمخض عن التماهي مع عدم تطابق المسطور مع الواقع، أو على الأقل وجود تقارب بينهما؟ وهي مسؤولية ثابتة لا مجال للتنصل منها أو إلقائها على الآخر، وذلك بالنسبة لأصحاب القرار السياسي في المقام الأول ثم بالنسبة لكل من يساهم بشكل أو بآخر في تجسيد هذه المفارقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ… » ولعل أخطر ما في الأمر هو نتيجة الإخلال بهذه المسؤولية المتمثل في مقت الله سبحانه وتعالى له كما هو مبين في الآيتين 2 و3 من سورة الصف حيث يقول جل جلاله « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) ». ولعل أجمل ما سمعته في تفسير الآيتين ما ورد على لسان الداعية فاضل سليمان، حيث أوضح أن السؤال الوارد في الآية 2 هو سؤال إنكاري، ذلك أنه لا يمكن للمؤمن الحق أن يقول ما لا يفعل، وعليه فالمستهدفون هم المنافقون المندسون في صفوف المؤمنين، وهذا القول يتماشى مع المقولة المنسوبة للحسن البصري حيث قال: » ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ».
قد يقول قائل بأن للآية أسباب نزولها، وهذا صحيح في نفس الوقت الذي تصح القاعدة الفقهية التي تقول ب »العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والتي تتماهى مع صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، من هنا يُخشى على كل من يقول كلاما أو يسْطُره في كتاب أو يتبناه دون أن يعزم على فعله وتجسيده في واقعه أن يدخل ضمن خانة المنافقين الذين يستوجبون مقت الله وغضبه لا قدر الله.

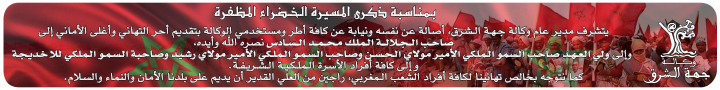



Aucun commentaire