هل من قيمة مضافة ترجى من وراء تأسيس حزب أمازيغي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
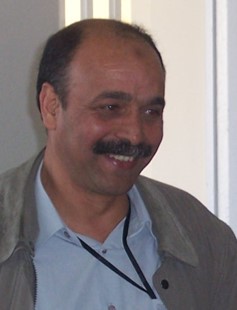
هل من قيمة مضافة ترجى من وراء تأسيس حزب أمازيغي؟
من بين ما قرأته مؤخرا مقالا تحت عنوان » تجاهل إمكانية تأسيس ‘أحزاب أمازيغية’ يطلق انتقادات لوزارة الداخلية » مفاده أن نشطاء أمازيغ ينتقدون مضامين التعديلات التي حملها مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ” تجاهلها” مطالبتهم بالسماح بـ” تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية أمازيغية ».
ولتبرير هذا الانتقاد تم الاستدلال بما نُسب إلى « رئيس جمعية تافيلالت للعيش المشترك » في قوله بأن « الهدف كان تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية وليس حزب أمازيغي أو عربي… »، مشيرا إلى أن « هذا القانون جاء بعد سياق تأسيس أحزاب بمرجعيات متعددة، خاصة العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية »، ومشددا على أن « المطلب يأتي انطلاقا من المرجعيات الدولية التي تمنح هذا الحق، في حين أن عددا من المغاربة اليوم لا يرون حزبا يُمثلهم »
واختُتم المقال بما ورد على لسان أحد أعضاء « مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي » حيث قال بأن « عددا من الشباب مؤمنون بالفلسفة الأمازيغية ولا يريدون يسارا أو إسلاميين أو غيرهم، بل يريدون حزبا بمرجعية أمازيغية »، وزاد: « هذا مؤلم حقا ويُعد عنفا رمزيا في حقهم ».
بالتمعن في المقال عموما، وفي المقتطفات المستنسخة أعلاه خصوصا، بغض النظر عن مضمون مشروع القرار الوزاري الذي لا يمكن أن يَستمد شرعيته إلا بالالتزام بمقتضيات الدستور، الذي ينص فصله السابع من الباب الأول بالحرف بأنه: « لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان ». ومن ثم يتبين أن هؤلاء « النشطاء الأمازيغ » يعتمدون منطق الانتقائية في تعاملهم مع النص الدستوري نفسه، بحيث يأخذون ما يناسبهم ويَلْتفُّون على ما لا يخدم أجنداتهم، ذلك لأنهم اخترعوا مصطلح حزب ذو « مرجعية أمازيغية » من جهة عوض « حزب أمازيغي » للالتفاف على منطوق الفصل 7 من الدستور المشار إليه أعلاه، محتجين في ذلك بحزب العدالة والتنمية على اعتبار أنه ذو « خلفية إسلامية »، وهذه حجة غير مستساغة لسببين، الأول هو أن هذا الحزب خرج من رحم « الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية » الذي أسسه الدكتور الخطيب سنة 1967، بعد انضمام عدد من النشطاء المحسوبين على الحركة الإسلامية إليه سنة 1996 دون أدنى تغيير في القانون الأساسي للحزب، ولم يتم تغيير الاسم إلى العدالة والتنمية إلا سنة 1998، والسبب الثاني هو أن الانتساب إلى مرجعية معينة من قبل مجموعة بشرية حزبا كانت أو جمعية أو دولة… يعني الرجوع إليها في كل أمورها الدنيوية والأخروية، دون الرضوخ للمصلحة الآنية التي يمكن أن تدخل في تناقض صريح معها، وعلى هذا الأساس فقط تكتسب مختلف المرجعيات مصداقيتها من قبيل المرجعية الاشتراكية، الماركسية، الليبرالية، وعلى رأسها المرجعية الإسلامية التي لا يمكن بحال من الأحوال حصرها في المجال التعبدي بمفهومه الضيق، ومن ثم فإن وسم مرجعية العدالة والتنمية بالمرجعية الإسلامية لا يستقيم، اللهم إلا إذا كان الهدف هو إفراغها من محتواها الدلالي، من خلال تلويثها بمرجعيات علمانية توجد على الطرف النقيض منها، مما يؤدي إلى خلق مرجعيات هجينة لا شرقية ولا غربية. ولعل ممارسة حزب العدالة والتنمية للحكم لولايتين متتاليتين يندرج ضمن هذا النوع من المرجعيات، وإلا فأي معنى يبقى للمرجعية الإسلامية عندما يتم غض الطرف عن تقنين القنب الهندي، والترخيص للكازينوهات والخمارات، وبناء جزء من مداخيل الخزينة العامة على مداخيل الخمور والسجائر، والتعامل بالربا، بالإضافة إلى فسح أغلبيته البرلمانية المجال أمام التيار الفرنكفوني للفرنسة التي تؤدي بالضرورة إلى إزاحة اللغة العربية عن لعب دورها المحوري في إسناد المرجعية الإسلامية، من خلال تزويد المتعلم بأدوات استيعاب وفهم النص القرآني والحديثي فهما صحيحا، والتي بدونها يسود الفهم الخرافي الذي نلمس تأثيره المباشر في الممارسات اليومية لعدد كبير ممن يُحسَبون على « المرجعية الإسلامية »…ومن ثم فإن الاحتجاج بمبرر كون حزب العدالة والتنمية أُسِّس على مرجعية إسلامية لا يستقيم.
من جهة ثانية يلاحظ اعتماد تأويل شاذ لفحوى الدستور المتعلق بمكانة المرجعيات الدولية في التشريع المغربي للمطالبة بتأسيس « الحزب الأمازيغي » مستدلين في ذلك بوجود شباب « مؤمنون بالفلسفة الأمازيغية ولا يريدون يسارا أو إسلاميين أو غيرهم، بل يريدون حزبا بمرجعية أمازيغية »، في إطار حق « حرية الرأي والتعبير »، وإلا اعتُبر ذلك « عُنفا رمزيا في حقهم »، كما جاء ذلك على لسان عضو « مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ». وقد كان من الممكن استساغة هذا التأويل لولا العمل الدؤوب لمعتنقي هذه المرجعيات على إحلال مقتضياتها مكان مقتضيات المرجعية الإسلامية، وهو ما يعد مسا صريحا بالدين الإسلامي، ويتناقض مع مقتضيات الفصل السابع من الدستور الذي ينص على أن الأحزاب « لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة ».
بغض النظر عن ما سبق، يبقى التساؤل عن طبيعة هذه « المرجعية الأمازيغية »، أهي مرجعية أجدادنا الأمازيغ التي كانت مرجعية إسلامية بامتياز، كما كان الشأن في عهد المرابطين والموحدين والمرينيين، والسعديين… على سبيل المثال، وهذا أمر يكذبه واقع النشطاء الأمازيغ عندنا، أم هي المرجعية التي كانت نقطة انطلاقها من الظهير البربري المشؤوم، الذي عمد فيه المستعمر إلى سياسة فرِّق تسد، والذي أصبح عدد من هؤلاء « النشطاء » يمجِّدونه ويعتبرونه بمثابة خارطة الطريق لتجسيد التمييز بين العرب والأمازيغ، الذين لا يمكن لأي منهم البرهنة على « نقاوة عنصره »، ولعلهم وظفوا خطاب الملك بأجدير، الذي نص على اعتبار الأمازيغية لغة وطنية، لتجسيد مضمون هذا الظهير بدءا بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 2001 الذي تم تزويده بكل وسائل الاشتغال، عكس « أكاديمية محمد السادس للغة العربية » التي تم تأسيسها سنة 2003 بهدف معالجة الاختلالات التي تواجه اللغة العربية في المغرب، والتي لا زال إنشاؤها لم يكتمل بعد!!! قد يقول قائل بأن الأمر عاديا بسبب اختلاف آليات الاشتغال في كل من المعهد الملكي والأكاديمية، لولا هذا الانسجام المبالغ فيه بين التيار الأمازيغي والتيار الفرنكفوني العلمانيين، الذي أصبح يُسخِّر كل الإمكانيات المتاحة للحيلولة دون سيادة اللغة العربية، بدءا بإبعاد الحرف العربي عن كتابة الأمازيغية الذي ظل سائدا لمدد طويلة بدءا من دخول الإسلام إلى حدود الستينات من القرن العشرين، واستبداله بحرف تيفيناغ الذي يعتبر وجوده في الأماكن والإدارات العمومية نوعا من « العنف الرمزي » ضد أغلبية المجتمع المغربي، إذ لا يمكن تصور عنف رمزي أكبر من مخاطبة شعب بلغة هجينة يصعب عَليَّ أنا الأمازيغي القح فهمها، خاصة عندما تُكتب بهذه الحروف التي لا يَعرف مدلولَها إلا مُنظِّروها.
ولعل التمعن في العلاقة بين التيارين الفرنكفوني والأمازيغي، يكشف نوعا من تقاسم الأدوار للحيلولة دون تبوء اللغة العربية المكانة التي يتيحها لها الدستور، باعتبارها اللغة الرسمية الأولى، سواء تعلق الأمر بعملية التدريس، أو بتداولها في مختلف الإدارات، التي لا زالت السيطرة التامة فيها للغة الفرنسية، رغم مرور 70 عاما عن « الاستقلال ». يضاف إلى هذا إقحام الدارجة في عملية التشويش عليها، من خلال اعتمادها من قبل عدد من وسائل التواصل الرسمية وغير الرسمية، وفي الإعلانات التي تمزج بين الدارجة والفرنسية بطريقة تثير الغثيان. والغريب في الأمر أن أكاديمية المملكة المغربية نظمت مؤخرا يومًا دراسيًا حول موضوع « كتابة الدارجة » تمهيدا لندوة وطنية قادمة، مع العلم أن « كل المداخلات كانت باللغة الفرنسية، مع استثناء وحيد وفريد » حسب ما صرح به رئيس « الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية »، واصفا اللقاء بأنه « كان فرنسيا بامتياز ».
في الأخير أتساءل عن القيمة المضافة المستهدفة من تأسيس حزب ذو « مرجعية أمازيغية »، وأنا على قناعة تامة بأنه لن يكون سوى آلية رسمية للعمل على تلويث المجتمع بالقيم الموسومة بالكونية وما هي بكونية، وسلخه عن القيم السمحة للدين الإسلامي، وعن ثوابت الأمة، علما بأن السماح بتأسيس حزب بهذه المرجعية لا قدر الله، سيفسح المجال واسعا أمام كل التوجهات الانفصالية والشاذة، للمطالبة بتأسيس أحزاب ذات مرجعيات وخلفيات خاصة بها، وما أكثرها، على اعتبار أن تطلعاتها لا تندرج ضمن برامج واهتمامات الأحزاب الأخرى.
الحسن جرودي
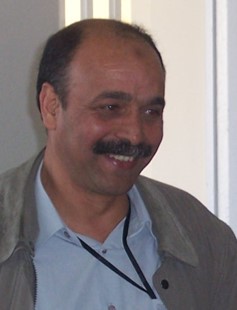





Aucun commentaire