بين تاونات وتارودانت مَسافة نَـأي وحُسن نسَاء
.jpg)
بقلم: إدريس الواغيش
حين اطلعت على لوائح التعيينات سنة 1983م أحسست أن الحظ قد خذلني، لأنني كنت أعرف أن مسارات كثيرة ستتغير في حياتي، لذلك كان عليّ أن أمضي مُـدَدًا زمنية ليست بالقصيرة بين ردهات المكاتب للتدقيق والتحقيق في مكان تعييني الأول، قبل أن أتأكد إن كان الأمر يتعلق بتاونات أو تارودانت، كان هناك تشابه كبير بينهما في الكتابة كما في النطق، ولأن مراكش وأكادير كانتا تغنيان عن أسماء مدن الجنوب، لم تكن معروفة لدينا بالقدر الكافي. حين تأكدت وأصبحت المسألة أمرا واقعا، حزمت حقائبي وخرجت في أول تجربة وأطول رحلة من نوعها، وعشت في بادية تارودانت ثلاث سنوات إلى حدود 1986م.
كنت أزور المدينة مع أصدقائي « الشّهريّين » من حاملي « الحوالات الصفراء » مثلي نهاية كل شهر، نأخذ حمّاما ساخنا أو نكتفي بدوش بارد في فنادقها الغير مصنّفة، وهي على كثرتها متفرقة كالفطر بين أزقة المدينة التراثية وواجهات ساحاتها الرئيسية، نتبضّع من قيسارياتها ما يتقنه حرفيّو المدينة من صناعات داخل أسوار المدينة النحاسية الملفوفة على نفسها مثل نسائها، ونقضي بعض المآرب الأخرى في دروبها الضيقة أو نتسكع بين أسواقها للتجسُّس على سيقات السائحات الشقراوات. ورغم أني كنت شابا مغامرا بالفطرة وسبق لي أن خضت عدة تجارب في السفر، إلا أنها كانت تنقصني أشياء أخرى في الرحلات الطويلة أولا وثانيا لم أكن متعوّدا على مسالك الجنوب، لذلك كان لزاما عليّ أن أحل بالمدينة يومين على الأقل قبل توقيع أول محضر في حياتي المهنية وكذلك للاستئناس بأجواء المدينة، وما ضاعف من معاناتي هو أنني كنت وحيدا في رحلتي تلك إلا من صبري.
أتذكر أن وصولي إلى أكادير كان في الصباح الباكر جدا، ومنها انطلقت إلى إنزكان وبعدها إلى تارودانت. تزامن وصولي إليها نهاية صيف 1983م قبل موعد عيد الأضحى بيومين، كانت أول مرة أحتفل به وحيدا منعزلا بعيدا عن الأهل، فما كان مني إلا أن اكتفيت بالبكاء طويلا في صمت تحت ظلال أشجار حديقة صغيرة وأكل كوميرا محشوّة بالسمك المُصبّر مع قنينة كوكاكولا. قضيت ليلتي الأولى في الفندق واحدا ووحيدا، حتى السياح الأجانب كانوا يزورون المدينة نهارا ويعودون إلى أكادير في المساء، قليل منهم يقيم في الفنادق المصنفة في المدينة على قلتها، في الصباح تفاجأت بكثرة الدراجات الهوائية تمر أمامي، تمتطيها شرائح عمرية مختلفة من الذكور والإناث، قال لي مالك الفندق والمقهى، رجل خمسيني طيب يحب الثقافة والمثقفين، ولم تزعجه كثرة أسئلتي حول عدة أشياء:
– وسيلتك الوحيدة للتعرف على المدينة يا ولدي، أن تكتري لك دراجة هوائية وتطوف في أحياء المدينة للتعرف عليها…!
بادرت إلى كراء دراجة هوائية وبدأت أطوف أزقة مدينة منبسطة تماما تحت لهيب حارق، ومع اقتراب منتصف النهار أصبحت المدينة خالية من الناس تقريبا إلا من سياح أجانب فرادة وجماعات يجوبون المدينة بكاميراتهم، حتى المحلات التجارية والفنادق كان أغلبها مغلقا، وحين سألت مالك الفندق، قال لي:
– مالكو هذه المحلات والفنادق والمقاهي يغلقونها كلما حلت مناسبة دينية، خصوصا في عيد الفطر وعيد الأضحى، ويقصدون دواويرهم ليحتفلوا بالعيد مع أسرهم وعائلاتهم، والتالي لا يبقى في المدينة إلا الساكنون فيها. بدأت في أتجوّل على الدراجة متنقلا بين أزقتها وأحيائها، أقصد بواباتها التاريخية، وحين تظهر لي أشجار الزيتون أو الجنان من بعض أبوابها الرئيسية، أعرف أنني على وشك الخروج من المدينة، فأعود أدراجي ثانية، هكذا أكملت طواف المدينة بشقيها القديم والحديث في ساعتين أو يزيد قليلا.
تارودانت مثلها مثل أغلب المدن السلطانية العتيقة في المغرب، تتكوّن من جزأين رئيسيين: جزء قديم وآخر عصري. المدينة القديمة في تارودانت عبارة عن ساحتين رئيسيتين: ساحة « أساراك » في جزئها الغربي وساحة « تالمقلات » في قسمها الشرقي، يفصل بينهما زقاق طويل، تحيط بهما أحياء بعض الأسماء فيها موغل في الدهشة والغرابة، بعضها مترجم عن الدارجة المغربية حرفيا بما تحمله من إيحاءات جنسية، وزقاق آخر أقرب إلى شارع يقطع المدينة مرة بشكل طولي وفي أخرى بشكل التوائي، بدءا من بابها الرئيسي في الغرب وصولا إلى مدخلها الشرقي.
المدينة الجديدة لم يستهويني فيها أي شيء، كانت ساعتها مجرد تجمعات إدارية موغلة في الملفات لا حياة فيها: مقر عمالة الإقليم ومصالح إدارية أخرى مثل الفلاحة والبريد والتعليم وباقي المصالح كمقرات الدرك والشرطة، وهي كلها مجتمعة تقريبا على ضفاف الطريق الدائري الذي يلف حول المدينة من الجهة الشرقية، يفضي إلى مركز « أولاد برحيل » ثم إلى مركز « إغرم » المؤدي إلى طاطا جنوبا لو انحرفنا نحو اليمين أو في اتجاه مراكش شمالا عبر « تيزي نتاست » أخطر طرق المغرب أو شرقا نحو مدينة ورزازات. عندما أحسست بالعرق يغمرني من رأسي حتى حذائي الرياضي أسفل قدميّ، عدت إلى الفندق الذي يطل على ساحة « تالمقلات » حيث أقيم وهي « مقلاة » فعلا كاسم على مسمى، أخذت دوشا باردا ونزلت ثانية إلى المقهى، أنتظر عودة مالك الفندق، كي أبدأ معه سيلا من الأسئلة الأخرى بداية من أصل اسم « تارودانت »، مرورا بأشياء أخرى كانت تبدو لي في بداية الأمر غريبة.
سطر أمامي المهاجر العائد من فرنسا في إسهاب سيلا من الأحاديث والروايات والافتراضات والاحتمالات الشفهية، تجمع في غالبيتها على أن الاسم يعود لامرأة كانت تصيح وهي ترى سيل وادي سوس، الذي لا يبعد كثيرا عن المدينة، يجُـرُّ أولادها إثر فيضان رهيب: « تارْوَا- دّانْت »، أي ما معناه بالعربية « الأبناء ذهبوا » أو « الوادي ذهب بالأبناء » في روايات أخرى، وقد حدث أن حوصرنا شرقا من وادي سوس وغربا من وادي الواعر ونحن هناك في المدينة إحدى السنوات ما بين 1983- 1986 وحاصرت فيضانات أطراف المدينة.
ويبقى الحديث عن الحرارة في تارودانت شهر شتنبر أمر غير ذي جدوى، هي التي يبدأ الصيف فيها مع نهاية شهر مارس وتتجاوز في الغالب الخمس وأربعين درجة، كنت أول مرة أشعر فيها أنني أقرب إلى قرص الشمس في السماء من الأرض وأنها جارتي الوحيدة، لا يفصل بيني وبينها سوى جلدة رأسي. انبهرت كثيرا أول مرة بعظمة أسوار المدينة وأبوابها وأبراجها، وبعض القصور التي تحول بعضها إلى فندق مصنف كبير. وجدت نفسي وسط عالم جديد تماما، ومختلف عمّا ألفته في الشمال: الكلام، اللباس، وجبات الأكل، ألوان واجهات المنازل وحيطانها المختلفة بين اللونين الوردي والنحاسي، أشكال الصناعات التقليدية المتنوعة الجلدية أو الفضية والنحاسية التي تبهر عيون الزائرين.
« تاملحافت » هو اللباس النسائي الأول بدون منازع في الجنوب، تصادفه عند النسوة بكل رتبهم العمرية بدءا من الصويرة، يفرض سواده في أزقة المدينة وأسواقها. لا شيء يعلو فوق السّواد، هو سيد الألوان في أزقة المدينة على الإطلاق، وقد تبدو لك أيضا بعضا من زرقة « تاملحافت » على قلتها في شوارع المدينة وأزقتها. لباس السواد في المدينة ليس تعبيرا عن حزن أو عزاء، لكنه اللباس اليومي للنساء الفقيرات ومن تنتمين إلى الطبقة المتوسطة في الغالب، وهو منتشر في مدن سوس عموما: أغادير، إنزكان، تزنيت وطاطا وصولا إلى تخوم الصحراء في مدن بويزاكارن وكلميم وطانطان والعيون والداخلة في أقصى الجنوب. ويبقى القماش الأزرق أو الأبيض العادي مع اللثام المطرز لباس الطبقة فوق المتوسطة اجتماعيا، لذلك قد تجد صعوبة في تحديد ملامح النساء الرّودانيات وشوابّها أو عمرهن، وهن تمشين في دلال ورد الياسمين بقاماتهن المديدة في الغالب، لولا أن يفضحه لون بشرة ناصعة البياض أو قمحية مائلة قليلا إلى السمرة ما فوق المعصمين وكذا العيون السود في الغالب، وقد لا تعرف مستوى تعليمهن، لكنك لن تجد كبير عناء في تحديد مستواهن الاجتماعي، يظهر ذلك بجلاء من خلال نوع الزينة والإكسسوار أو اللباس ولونه وحتى نوع الخفين أو شكل اللثام الموضوع على الوجه، لأن تكلفة تطريزه اليدوي ليس في إمكانية الجميع، كل هذه العلامات تحدد بوضوح المستوى الاجتماعي للمرأة الرّودانية على العموم، والنساء الرّودانيات تمزن بحُسن وخفة دم وخصوصا في بوادي الأطلس الصغير جنوبا.
عملت طيلة هذه المدة في مدرسة بدوار أكرض نوالوس قبيلة إدا وزكري دائرة إغرم، كانت تمر قربها طريق لا محيد عنها بالنسبة للسياح من أجل العبور من ورززات إلى تافراوت، والمنطقتان أكثر جذبا للسياح من مختلف بقاع العالم، لأنهما سياحيتان بالدرجة الأولى: ورزازات معروفة كمدينة القصبات والسينما العالمية وتعرف عادة بهوليود إفريقيا، وتافراوت بدورها مدينة يبدأ فيها الجمال كي لا ينتهي، هذه الطريق كانت في واقع الأمر غير معبدة، لكنها تظهر في الخريطة السياحية للمغرب عكس ذلك، كان في الأمر دسيسة سياسية ما وتلاعب بأموال الوطن تم أكلها بالغش والتحايل، وهذا ما كان يخلق مشاكل بالجملة للسياح الأجانب، ويعتبرون أن رسم الطريق في الخريطة معبدا فيه نوع من التحايل عليهم.
ذات أمسية ربيعية، وقفت أمامي سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج تحمل في داخلها رجلين وسيدتين أجنبيتين، تبيّن لي من النظرة الأولى أنهم سياح ألمان. تكلمت معهم باللسان الفرنسي فلم يفهموا شيئا، عرفت بداية أنهم لا ينتمون إلى العالم الفرنكفوني. كانوا جميعهم في العقد الخامس تقريبا أو ينقص قليلا، يمتلكون شعرا أشهبا وقامات طويلة، خمّنت للوهلة الأولى أن يكونوا من الجنس الألماني، سألتهم باللغة الإنجليزية، كنت لا أزال أتقنها بشكل جيد تقريبا، حاولت أن أجاملهم بسؤال كنت أعرف بالتجربة أن الألمان على الخصوص يحبذون سماعه أكثر من غيرهم:
?You are Deutsch Mann
كان إطراء مني، لكن تبين لي أن الناس لا يحملون من طباع الألمان إلا الشكل، كانوا عكسهم تماما، وديعون ومؤدبون كأنهم أخذوا كثيرا من أخلاق قريتنا « أيلة »، قبل أن يجرفها تيار العولمة نحو الهاوية. أجابوني:
– لسنا بألمان، لكننا جيرانهم…!
تبيّن فيما بعد أنهم نمساويون، سألوني عن الطريق المؤدية إلى تافراوت والشمس على وشك المغيب، ضربت الاخماس في الأسداس، قلت لهم:
– الطريق كما ترون غير معبدة، ولا يمكنكم بأي حال من الأحوال أن تصلوا إلى مقصدكم إلا بعد ثلاث ساعات تقريبا، ووارد أن تحيدوا عن الطريق، فتصبحون مع طلوع الشمس في جنوب الصحراء، إن لم تأكلكم الضباع في ليل الصحراء الرهيب…!
لم يكن قصدي في الحقيقة أن أرهبهم، لكني كنت صادقا معهم، انطلاقا من معرفتي بالطريق الغير معبدة إلى حدود مركز آيت عبد الله، وهي معروفة بكثرة المنعطفات تفضي إما إلى دواوير أو قبائل متفرقة، وأيضا من خلال تجربة سائح فرنسي كان قد مر بها هو وزوجته وحكاها لي والعهدة عليه، بعد أن ضلا الطريق إلى تافراوت ومالا شرقا إلى صحراء طاطا. أحسست أن الخوف قد لبسهم من رؤوسهم إلى أقدامهم، بدأوا ينظرون إلى بعضهم البعض ويتكلمون في همس بلغتهم. سألوني في إشفاق واضح:
– والآن ما العمل يا سيدي…؟
قلت لهم:
– لا سبيل أمامكم إلا المبيت هنا، وفي الغد انطلقا…!
استحسنا الفكرة، وقد كان وجود المدرسة على الطريق عاملا مطمئنا لهم ولكثير من السياح، لأنهم يعرفون أن الدولة وأمنها حاضر معها. شرحت لهم أنه لا داعي للقلق، وأنهم سيكونون في ضيافتنا وسنقوم بما تمليه علينا ثقافتنا وكرمنا المغربي وفق ما نمتلكه من إمكانيات. كنا نعيش ما بين نهاية فصل الشتاء وبداية موسم الربيع. ارتأيت أن استضافتهم في المنزل الذي وفره لنا الأهالي كمعلمين فكرة غير صائبة. قال لي صديقي الجيلالي الذي كان يدرس معي في نفس المدرسة مازحا:
– إلا أن يبيتوا معنا في المنزل، استبعد الفكرة من رأسك، سنفتضح معهم…!
لم يكن المنزل على بساطته في مستوى أن ندخل إليه ضيوفا خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بسائح أجنبي، سيأخذون فكرة سوداء عن معاناتنا كمعلمين مع السكن، لذلك استقر الأمر على أن يبيتوا في القسم، وأن نوفر لهم كل ما يحتاجونه. كانت السماء صافية إلى حدود ما بعد منتصف الليل بقليل، لم يخطر ببالنا أن عاصفة ثلجية ستباغتنا وتغطي المنطقة من دون سابق إنذار أو سقوط مطر. كانت ليلة باردة جدا، كأن السحب الماطرة وندف الثلج كانت متربصة بنا وراء قمم جبال الأطلس الصغير الصحراوي الصلعاء بلونها الأحمر، أكدت لي أن الأوروبيين يشتكون من البرد أكثر منا في غياب الإمكانيات. سقط الثلج من دون سابق إنذار وبحجم أكثر من المتوقع، قام أحد السكان المحليين من جيران المدرسة بالواجب، ولم يبخل علينا بإحضار كل ما نحتاج إليه من بيض وزيت وخبز ومواد أخرى لإنقاذ الموقف، أمدنا بما احتاج إليه الضيوف من أطعمة وبعض الأغطية الإضافية. في الصباح بدأوا في جمع نقود مغربية وأخرى بالعملة الصعبة وأنا أراقب تصرفاتهم بحكم قربي منهم وترجمانا لهم، كان قصدهم أن يعطونا ثمن المبيت والمأكل. قلت لهم ما تعلمناه في صغرنا بالمدارس:
– نحن أهل كرم، اجمعوا نقودكم…!
بدأت إحدى السيدات منهم تنظر إلى السماء في ذهول، وعندما رأيت أن المسألة قد تكررت، قلت لها:
– ما بك؟، لم تنظرين إلى السماء هكذا في كل مرة…؟
قالت لي ببراءة وثقة زائدة:
– أنظر عسى أن تحط طائرة الهليكوبتر…!!
ولما سألتها ضاحكا عن سبب هبوط الهليكوبتر، أجابتني:
– في النمسا يعتبرون مثل هذه المدرسة نقطا سوداء، وعندما تسقط الثلوج كما الآن، يحملون للأساتذة كل ما يحتاجون إليه من طعام وحاجيات أخرى…!
ترجمت ما قالته لي السائحة النمساوية للأهالي ولصديقي الجيلالي، كادوا يموتون من فرط الضحك، وضحكوا أربعتهم بدورهم معنا، وفي النصف الثاني من اليوم، كان الثلج قد ذاب في الأرض، لأنه لا يعمر طويلا عادة مهما سقطت من كمية، تابعوا هم طريقهم مع تقديم ما يلزم من الشكر، وبقينا نحن ننتظر الطائرة التي لن تأتي أبدا…!!.


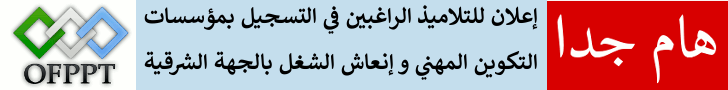

Aucun commentaire