من سيرة ولد الجبال: وحيد في غابة وَادْ الناشف
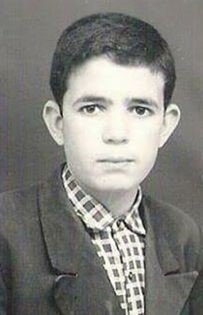
رمضان مصباح الادريسي
في سيارة جدي:
إنها أول سيارة أركبها ،وأنا واع بها،ثمل برائحتها ،متذكر لكل بهجة الركوب، إلى يومنا هذا . سأظل أتذكر كل تفاصيل ارتقاء الحفيد إلى ركوب سيارة الجد؛القائد محمد الذي لا يقربه حتى أخوالي إلا بمناداة منه.
هيأتني الوالدة جيدا لهذا السفر،وأرقني تصوري جالسا إلى جانب خالَيَّ وجدي ؛ في غياب والدي أو والدتي. من سيسندك يا رمضان في يومك هذا ،وباكورة أسفارك،التي جادت بها علقة تائهة في دَفَق الوادي؟
كيف تتعامل مع جد،بعشرات الأحفاد أمثالك؛ لم يكلمك أبدا،وبالأحرى أن يحنو عليك،ويُسَميك على الأقل؟
لم تكن الأسر ،كما اليوم،تُحِل الأطفال مكان الصدارة؛كان أقصى ما نحلم به ألا نُضرب؛أما نصيبُنا من العاطفة فلم يعلمنا أحد أنه حق لنا.
لم نعرف الحرمان أبدا، لأننا لم نعرف الإشباع العاطفي أبدا؛إلا ما كان من عاطفة الأمومة التي اقتنعنا بأنها كل ما يمكن أن ننتظره من حياتنا الجبلية القاسية كلها. كم تُعلم هذه الجبال القسوة في كل شيء.
لم ينتبه أحد من الكبار إلى أنها ،وان قست ،تَشَّققُ فيفيض منها الماء.
ارْكَب يقول خالي.وكيف ؟ مقدما رجلي أم رأسي؟ وهل يُخمن خالي البشير سؤالي الباطني هذا؟
على أي دُفعت إلى داخل الأوبيل دفعا؛وكلي اضطراب لأنني ،من جهة خلف جدي، بكل أناقته البيضاء ،ومن جهة أخرى محط أنظار الأطفال ،الذين بكروا لحضور سفري.لا ليس سفري ،بل مشهد السيارة وهي تغادر صوب وجدة.
كنا نحرص على هذا ،لكن لم أتصور أبدا أني سأكون ،يوما ما، ضمن الراكبين.
قد يكون من عصابة الأطفال ،الشُّعث الغُبر،من تمنى – يومها – لو كانت العلقة في حنجرته حتى يكون هو المسافر؛ليس حسدا وإنما من غِبطة.
لم يكن الصغار يسافرون إلا مرضى ، وعلى وشك الهلاك.
هاهي السيارة تتحرك ،وكُلّي مزيج من خوف وزهو،لم أعشهما أبدا بنفس الاحساس.
وما كل هذه النعومة التي تجلس عليها ،وتنفذ دغدغتها الباردة واللذيذة، من ساقيك الى أعماقك؟ ؟ أسترق النظر الى الراكبين ،وأتساءل بيني وبين نفسي :لماذا لا
يبدو عليهم أنهم سعداء مثلي؛أو حتى خائفين؟ هل تدغدغهم ،هم أيضا، هذه المقاعد الملساء؟
عجبا كم عدوت في مرتفعات « أيرواو » كأرنب بري ،ولم أشعر بما أشعر به الآن ،وأنا ضمن ركاب الأوبيل.
هل السيارة، هي التي تتحرك أم الجبال ؛أم حواشي الطريق؟
ساد الصمت ، تهيبا ووقارا،وظللت وحدي ،تارة تحاصرني أسئلتي،وتارة أحاكي ،وان صامتا، هدير المحرك.
ثم أنظر وأقارن ،بين تقدم السيارة وانجراف الجبال وراء وراء؛ غير منتبه الى دوران غريب في رأسي؛انتهى بي وقد أخرجت بعض ما في جوفي من فطور الصباح. ها أنذا أخالف أولى وصايا الوالدة: حينما تركب السيارة انظر أمامك يا رمضان ، حتى لا تتقيأ.
كيف انظر أمامي فقط ،وليس أمامي سوى جدي؟ ومن يتفرج على جبال تسير؟
كرر خالي البشير الأمر، بحدة ،فخفت أن يُلقى بي خارج السيارة ،وداخل التيه، بين هذه الجبال التي أجهل تماما. أين أنت ياجبالي التي أعرف ؟
ولا أذكر هل انتبه جدي إلى ما حدث لي ؛ولعل قصر قامتي خلفه أنجت جلابيبه من أذاي .
عبرنا ما عرفت في ما بعد أنه مجرى وادي اسلي الشهير؛ومنه إلى الطريق الرئيسية التي تصل وجدة بجرادة.
لفت انتباهي تغير أحوال السيارة؛من اهتزازات متتالية،ونَقْع تخلفه وراءها كلما أسرعت، إلى اتزان و سلاسة ونقاء بفعل الطريق المعبدة.
رعب الوحدة في قلب المدينة:
ستتبخر كل الرُّفقة الموجودة الى جانبي في السيارة – جدي وابناه البشير ومومن – لأجد نفسي وحيدا وسط غابة « الأوكاليبتيس » المحاذية لحي « واد الناشف » القديم.
وحيدا داخل السيارة؛من يحرس من؟ على هذه الهيئة استقبلتني وجدة في أولى خطواتي بها. وهل نزلت من السيارة ،حتى تتحدث عن الخطوات؟
لا لم تلمس قدماي بعد تراب وجدة.
لقد قرر جدي – حسب تفسير الوالدة لاحقا – تناول فطوره،رفقة خالي لدى بنته القاطنة بالحي :خالتي عائشة .
كان هذا سيبدو عاديا جدا ،لولا القرار الخطير الذي ترتب عنه:
ترك طفل صغير – في ساعته الأولى بمدينة كبيرة – داخل السيارة ،وسط غابة موحشة .لم يخبروني بشيء،ولا كلفوني بشيء،ولا حتى كلمات تطمئنني .. ذهبوا الى حال سبيلهم وتركوني جالسا مع هواجسي الآخذة في الصراخ بداخلي ،ولو بدون صوت. لم يتبق لي من سند ،في وحدتي هذه، غير الأوبيل الخالية،أتفرج على مباهجها الداخلية على هواي. أحاول أن ألمس بعضها فأتذكر أوامر الوالدة فأكُف. وأحيانا أتخيلها وقد انطلقت ،فأحار ،ماذا أنا فاعل؟
يمر الناس أمامي ،يحادثون بعضهم بعضا ؛ومنهم من ينظر صوب السيارة عَرَضا ،فأخاله يريد بي شرا ؛ولا ينقشع غمي إلا والعابرون قد ابتعدوا.
وقتها كانت السيارات قليلة جدا ،وهذا ما يفسر فضول العابرين.
أنظر في جميع ألاتجاهات عسى طلعة القائد والخالين تُبدد خوفي ،وتُخلي بيني وبين فرحة السفر ،أعانقها ثملا ،لكن بدون جدوى.
أخيرا تبددت هواجس ساعة أو أكثر ،بقدومهم؛ومرة أخرى لم يكلمني أحد ،وكأني مجرد متاع مُلقى داخل السيارة.كم كانوا غِلاظا قساة القلوب،في كل أمورهم العائلية؛غِلظة طبيعية فيهم،وليس قسوة مقصودة.
وهل فكروا ،وهم يفطرون لدى الخالة، في طفل وحيد في مواجهة وجدة؟
لا أذكر كيف استُقبلت بمنزل عمي ،ب »رأس عصفور » ،قرب سينما النصر؛وكل ما احتفظت به الذاكرة هو اصطحابي الى مستشفى « مريس لوسطو ».الفارابي اليوم.
تشتغل الآن » الذاكرة الأنفية » فأستعيد ما عبقت به ردهات المستشفى من روائح جديدة كل الجدة على أنفي الصغير، القادم من الجبل ممتشقا حاسته القوية.
كان كل شيء في غاية النظافة ،وفي غاية العبق الطبي .كل شيء براق ولامع ،أما الأرضية،و قد كانت من « الموزاييك » الأصفر،فقد بدا لي أن من العيب أن أمشي فوقها بنِعالي المتآكلة؛تذكرت أمي وهي تنهرنا حتى لا نطأ أفرشة المنزل ،وهي دون هذا النقا المحيط بي .
كانت الردهات طويلة لا تنتهي ؛وكل من بها مسرع لا يلوي على شيء.
لا يكاد عمي يسلم على أحدهم ،حتى يبتسم للآخر ويمد له يده.لغته لم تكن لغتنا المألوفة ،ولا القوم يشبهون الناس الذين أعرف.
ممرضات وممرضون ،طبيبات وأطباء ،تحضرني الآن سُحناتهم الشقراء ،ولطافة وجوههم،وهم يستفسرون عمي عن الخطب الذي حل بي. فهمت هذا من نظراتهم،بل حتى من ابتساماتهم في وجهي.
كيف ؟ يبتسمون لي أنا القادم مع جد أهملني في الغابة؟
عجبا هؤلاء الشقر يبتسمون حتى للأطفال ،خلافا للعبوس السائد في الجبل.
كيف أصبحت مُهما الى هذه الدرجة؟ لم أع لقائي الأول مع الطبيبة الفرنسية التي أنقذتني من موت محقق؛أما هذا الاستقبال الفرنسي البشوش ،في موريس لوسطو،فأستحضر كل تفاصيله الآن.وأكاد أتذكر حتى كلام عمي ،وان كان بفرنسية لا أفهمها.ولأول مرة أكتشف أن هناك لغة أخرى غير التي نعرف في جبل الزكارة. انطبعت في عمقي لغة بشوشة ،تحب الأطفال. وهل للغة أن تحب أو تكره؟ على أي هذا كان احساسي الطفولي..
تتضح الذكرى أكثر فأراني داخل قاعة بيضاء أنتظر شيئا ما سيحصل ؛أنتظر شيئا لأن عمي يذرع القاعة،مرتديا وزرة بيضاء، من خزانة الى أخرى ،وهو يحمل بين يديه لوازم طبية يضعها على الطاولة أمامي.
وما أن رأيت الملقط المعقوف حتى فهمت القصد؛وأيقنت أن دقائق علقتي أصبحت معدودة.
كان عمي في غاية البشاشة ،خلافا لأخوالي ؛وبين الفينة والأخرى يلاطفني ويُطمئنني بأن ما في حلقي سيزول الى الأبد؛لكن شريطة ألا أعود الى شرب الماء من العين على طريقة الحيوان.
كبرت ثقتي فيه ؛واعتبرته سندا لي في هذه العوالم البيضاء؛ بحيث لما ولج الطبيب الفرنسي القاعة لم يُرعبني ؛رغم ضخامته وقامته الفارعة. كان فِضِّي الوجه ،مداعبا لمن حوله ؛دون أن يُغفل الابتسام في وجه هذا الجبلي الصغير ، الذي يقف الآن مواجها فرنسا – للمرة الثانية – حاملا علقة في حنجرته.
أذكر الآن بكل وضوح كيف تَوَّج جبينه بمصباح شديد الإنارة ،واقترب مني ،ووجنتاي بين راحتي عمي الدافئتين. فحص حنجرتي بملقط مُقَطن،وضمَّخها بسائل مر ،ثم هوى ،بلطف،عميقا حتى خِلته سيدخل كل كفه في فمي.
انتفضت إذ غالبني القيء ،خشية إن أفعلها كما حدث في سيارة جدي؛لكن الرجل لم يأبه لِحرجي ولم يعنفني؛إذ كانت نصب ضوئه وملقطه عَلَقة في غير محلها ،ويجب أن يقتلعها من بحبوحة علوقها،صونا لدم لم تصنه كل خرافات الجبل.
ها هي الآن أمام عيني ،تتلوى ،مكتنزة دما ، برأس الملقط؛والطبيب آخذ في محادثة من حضر،والنظر إليها. كم صمدتِ لكل التخاريف التي كادت تقتلني ،وها أنت الآن موضوع فرجة طبية؛غريبة مثلي في مكان غير مكانك.
عُدت مع عمي الى المنزل؛ورغم ما بي من وهن ،وكثرة ما مر بي من أحداث، في هذا اليوم،خرجت الى الزقاق أتفرس في وجوه الناس ،ثم انتقلت بخطوات جريئة الى مكان مشرف، لتتضح لي رؤية الطريق ؛وملاحقة السيارات العابرة ،بالنظر، الى أن تختفي .
ها أنت الآن يا رمضان تعيش متعة المدينة- ولو في زقاق ضيق،مُعافى بعد أن خلفت وراءك في موريس لوسطو » علقة قيضت لك سفرا لم تحلم به أبدا.
فرب ضارة نافعة..
ينقطح حبل الذكرى لأجدني بين يدي الوالدة في مستفركي ،والكل من حولي منبهر بما حدث لي ، يستمع الي مشدوها وأنا أنظم قصائد وصف لا تنتهي.
قصائد أستعيدها الآن ؛وقد غيب الموت – كما سيغيبنا – أغلب من كان شاهدا على هذا اليوم.اليوم الأشد طولا في حياتي كلها.
لعل أطفال الدوار كلهم تمنوا لو كانت علقتي من نصيبهم.
https://web.facebook.com/groups/mestferkiculture51


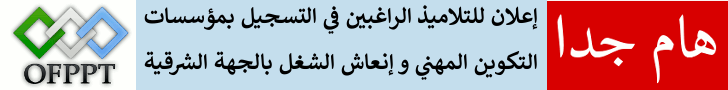


Aucun commentaire