قراءة سوسيولوجية لأحسن القصص 20 بقلم عمر حيمري

بعد أن عالجت قصة يوسف عليه السلام ، كثيرا من الظواهر الاجتماعية والنفسية والإنسانية ، كظاهرة الحب العنيف المتمثل في تحرش زليخة ونسوة المدينة وكيدهن ليوسف عليه السلام والحب العفيف والذي أسميه بالحب » الإيماني » والذي يكون دائما قويا خالصا ولكنه مسيطر على القلب والجوارح لارتباطه بالإيمان وبتعاليم الدين وبمراقبة الله والخوف منه وبترفع صاحبه عن الحب الحسي المادي الهابط المتشبع بالغريزة الحيوانية . وظاهرة الحسد وصراع الأجيال والحزن وتبعاته والظلم وتداول الأيام بين الناس وغيرها من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية ، التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني ، كالصدق والكذب والافتراء على الآخر ظلما وعدوانا والتوبة والرجوع إلى الله وإلى الحق والصبر والتحمل … إلى غير ذلك من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية ، التي سبق أن اشرنا إليها سابقا .
انتقل الحق سبحانه وتعالى من هذا ، إلى تنبيه وتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم ، بأن ما أوحاه إليه ربه وعرفه عليه وأطلعه عليه من أخبار يوسف ورؤياه وإخوته وأحوال أبيه يعقوب عليهما السلام وكل ما ورد في القصة وذكر من حكمة فيها ، هو من أخبار الغيب ، الذي لم يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده ولم يكن له به علم . [ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ] ( يوسف آية 102 ) وذلك لحكمة يبتغيها الله سبحانه وتعالى من وراء وحيه للقصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وتشجيعه على الصبر وعلى تحمل أذى قومه وما يناله منهم وليعلم أن من سبقه من الرسل أوذوا وعذبوا ونالهم شر كثير وابتلوا بلاء شديدا ، ولكنهم صبروا وتسامحوا وأخذوا بالعفو وبلغوا ما أمرهم الله به فأيدهم الله بنصره ومكنهم في الأرض وفازوا بالنصر على عدوهم وبرضى الله .
فلا تبتئس يا محمدا من إعراض الكثير من قومك عن تصديقك والإيمان بما جئتهم به ، فتلك سنة الله يجريها على المشركين ، فهم معاندون مكابرون وخاصة منهم المترفون ، لطبع في نفوسهم وشر جبلوا عليه ، يمنع أكثرهم أن يكونوا مومنين . وهذه ظاهرة نفسية تتكرر عبر الزمكان ، فهذا مثلا قوم فرعن الذين أوتوا تسع آيات بينات ومع ذلك ، لم يومنوا ولا هم صدقوا برسالة موسى عليه السلام ، الذي فهم عنادهم وتأكد بأنه لا طائل ولا فائدة من وراء الإسرار على دعوتهم فدعا ربه : [ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنون حتى يروا العذاب الأليم ] ( يونس آية 88) . نجد هذا الإسرار والتشبث بالكفر ورفض الإيمان بما جاءت به الرسل ، نجده تكرر كذلك مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخبره الله بهذه الحقيقة فقال : [وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين وما تسأله عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأية من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ] ( يوسف آية 103 / 104 / 105 /106 /107 ) .
لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ، يحمل هما كبيرا وحرصا شديدا على إيمان قومه ، خوفا منه عليهم من عذاب شديد في الآخرة ومن ضنك ومشقة في الدنيا ينتظر المشركين منهم وإلى جانب هذا الخوف على قومه ، كانت له صلى الله عليه وسلم رغبة قوية ، في إيصال الحق والخبر اليقين والخير الكثير، الذي جاء به إليهم من عند الله . ولكن الله سبحانه وتعالى العليم بعالم الغيب والشهادة وبعالم الوجود والعدم وبعالم الممكن والمستحيل والذي لا يستحيل مع قدرته سبحانه وتعالى شيء أراده أن يكون أو لا يكون وهو الذي أحاط بكل شيء علما ، لا شيء يخرج من دائرة إرادته وعلمه وقدرته وتقديره . [ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ] ( الرعد آية 9 ) . [ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ] ( الملك آية 14 ) هذا العليم الخبير بقلوب عباده والمطلع على نواياهم وأحولهم وطبائعهم ، يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم وينهي إلى علمه أن حرصه ورغبته على إيمان قومه ، لن يجر الكثير من قومه ولن يسوقهم إلى الإيمان . لأن قلوبهم عليها أقفال ، فهي منكرة مظلمة ، لا تدرك ولا ترى الآيات والدلائل المحيطة بهم والتي يمرون عليها بالليل والنهار ولا يشعرون بها و لا تحرك فيهم ساكنا ، لإعراضهم عنها وعدم الالتفات إليها ، فهم غير مؤهلين ولا جديرين بالإيمان ولا هم قادرين على استيعاب الدلائل والعلامات والآيات والمعجزات المنتشرة حولهم والتي تملأ الآفاق والتي من شأنها أن تدفع إلى الإيمان دفعا ، وأنت يا محمد لا يهمك من أمر إيمانهم شيئا ، فأنت غني عن إيمانهم ولا تطلب منهم أي أجر مقابل دعوتك لهدايتهم فهم منصرفون عن الهداية وهي التي تهدى لهم بلا أجر ولا مقابل [ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ] ( سورة يوسف آية 104 ) . أفلا يعلم هؤلاء المشركين الضالين ، أنهم ليسوا بمنأى من عذاب الله وعقابه ، وليسوا بمعجزين . أم أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى وعذابه وإقامة القيامة عليهم وهم في غفلة يلعبون لاهية قلوبهم منشغلون بدنياهم ومهتمون بالإسرار والحرص على كفرهم وشركم فتبهتهم الساعة وتأخذهم على حين غفلة منهم . فاستحقوا ما هددهم به سبحانه وتعالى – وهو واقع بهم لا محالة – فقال في حقهم : [ أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ] ( يوسف آية 107 ) .
بعد هذا التبيين الواضح والكشف الفاضح ، لسريرة وطبيعة النفس المشركة وجه الله سبحانه وتعالى نبيه وأمره بالكشف للمشركين عن النهج المستقيم والطريقة التي لاعوج فيها ولا شك وشبهة ، إن نحن اتبعناها فهي توصلنا للهداية ولنور الحق وهي الطريقة التي تبعها في دعوتي أنا ومن تبعني لا نحيد عنها ولا نبغي عنها بديلا . فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بألوهيته وتوحيده وانفراده بالروبية سبحانه وتعالى ، فنحن موحدون وهذا ما يميزنا عن المشركين والكافرين ويجعلنا نختلف عنهم كليا ، فنحن نسير على نهجنا هذا ، على وعي وإدراك تام ومعرفة يقينية لا شك فيها وندعو كل من أراد أن يتبعنا ويعتقد نفس عقيدتنا إلى النهج نفسه ، ومن أبى فالنار موعده . يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى ، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم [ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ] ( يوسف آية 108 ) . هذه سنة الله وقوانينه الجارية في خلقه يذكر بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، بأنه لم يرسل في الأمم السالفة والسابقة إلا رجالا من بني آدم هم من جنس من أرسل إليهم ولم يرسل ملائكة ولو افترضنا انه سيرسل ملائكة فسيجعلهم رجالا وذلك لاستحالة رؤية الملائكة لأنهم ليسوا من جنسهم ، فهم من طبيعة نورانية وبني آدم من طبيعة مادية ، ترابية : لقوله تعالى [ و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ] ( الأنعام آية 9 ) . لقد أرسلناك إلى قومك ، كما أرسلنا إلى من سبقوك من الأمم رجالا ، كإبراهيم ولوطا وصالحا وشعيب وموسى وعيسى ووغيرهم من الرسل ، كما أرسلنا إليكم محمدا ، فإن كنتم لا تصدقون ، فاسألوا أهل الذكر والعلم السابقين عليكم . يقول الله سبحانه وتعالى : [ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من فبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ] ( يوسف 109 ) . إن الله يبعث الرسل بشرا من بني آدم إلى الناس فإن كذبوا واسروا على الكذب واستمسكوا به ، ويئس الرسل وملوا من دعتهم وظنوا أنهم لن يستجيب لهم قومهم وقد بلغ منهم الياس والخوف والجهد مبلغه تساءلوا ، متى يأتي نصر الله جاءهم الرد من الله سبحانه وتعالى [ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ] ( البقرة آية 214 ) . فعندما يبلغ التكذيب أوجه ، واليأس من الرسل مداه ، يأتي نصر الله للرسل وللمومين ويصب بأسه وعذابه على المجرمين المكذبين . [ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ] ( يوسف آية 110 ) . إن قصة يوسف عليه السلام غطت مجال السورة كلها فهي بدأت وانتهت في سورة واحدة توافق فيها الواقع بالغيب ، فهي رؤية رآها يوسف عليه السلام وهو صبي ورافقته حتى أصبح عزيز مصر له شأن عظيم ، لقد صاحبت الرؤيا يوسف عليه السلام ، منذ صباه وغطت عمره كله وكانت بأمر الله تتحقق رويد رويدا وساعة بعد ساعة ومرحلة بعد مرحلة في تناسق كامل وتام مع الموضوع العام وتتوافق مع الواقع ويتحقق فيها وعد الله وينجح يوسف في كل الابتلاءات والامتحانات التي تعرض لها ومر بها ، من قاع الجب إلى العبودية إلى السجن ومرارة الظلم إلى التمكين في الأرض والوصول إلى السلطة والجاه على خلاف القصص الأخرى كقصة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى …
لقد عالجت قصة يوسف العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسية ، التي سبق ذكرها والتي لا يخلو منها أي مجتمع في أي زمان أو مكان ، فهي نموذج فريد لا عوض لنا عنه ولا بديلا ، في معالجة ما يعترضنا ويصطدم بنا من ظواهر أخلاقية أو اجتماعية أو نفسية منحرفة ، قد تحدث في مجتمعنا المعاصر استعصى علينا حلها ومعالجتها ورسمت لنا الطريق العريض للنجاة من الآفات والمخاطر ، التي تهدد المجتمعات في كل عصر ومصر ، فكانت بذلك حقا عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة للمومنين وباعثة لهم على التقوى والإيمان ، ولم تكن مجرد حديث مفترى ، بل هي مشاهدة لدلائل ووقائع ومعجزات تتحقق في الواقع أثناء القصة ، والله سبحانه وتعالى من ورائها هو المتصرف ، وصدق الله العظيم ، إذ يقول في نهاية القصة [ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يومنون ] ( يوسف آية111 ) : بقلم عمر حيمري ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين .


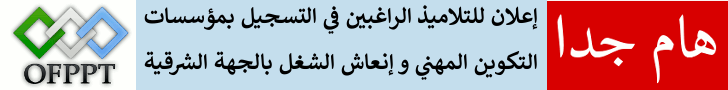

Aucun commentaire